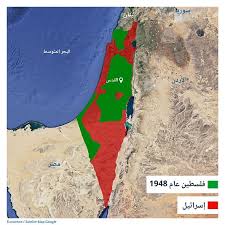أرغب في البكاء، بكاء شديد لا أصحو منه. بكاء يجعلني أطفو على سطح دموعي التي لولا جفافها لجرفني تيارها حتّى التلاشي. أشعر بملوحة دموعي لا بمائها. أرغب… ولكن رغباتي لا تتحقّق … حتى الدموع منها.
لن تعيد دموعي بناء ما تهدّم. لن تنقذ ذاكرة أحياء وأزقّة وحوانيت استحالت ركامًا. لن توضّب البيوت في فوضاها الدافئة، لن تعيد الغبار إلى رفوف مكتبات بناها أصحابها كتابًا كتابا. لن تحيّد الصالونات عن آلة التدمير بانتظار ضيوفٍ رُتّبت لإجل استقبالهم. لن تبثّ دموعي الحياة في غرف الجلوس حيث صخب الأمسيات وهمس الصباحات وضجيج الأطفال والاحفاد في كل الأوقات.
لن تُطعم دموعي أطفال غزّة الجياع، لن ترمّم أعضاءهم المبتورة، لن تقيهم البرد القارس، لن تهزم الصقيع الذي ينهش الأبدان الطرية ويقتات بها. لن تعيد دموعي العائلات إلى سجلّات النفوس. لن تخرجهم من الأكياس البيضاء التي جُمعوا في داخلها أشلاء، لن تمنحهم موتًا بشريّا ودفنًا انسانيّا وقبرًا وشاهدًا وجنازةً وعزاء.
لن تجعل دموعي من الحرب على لبنان مجرّد خيالٍ علميّ قذر. لن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، لن تجعل الواقع مجرّد احتمالٍ لسؤالٍ افتراضيّ : ” ماذا لو اندلعت الحرب على لبنان ؟”
لن يتوّحد اللبنانيون رأفةً بدموعي. ولو فعلوا ذلك لانهمرت فرحًا من دون رجاء ، ولربّما أطلقت زغرودةً طويلة رغم كل الأسى المحيط. لن يتوحّد اللبنانيون بكيت ام لم أبكِ، ولن يرضوا حتى بالتخلّي عن لغة الشماتة والتخوين وعن اعتبار كلّ طرفٍ امتلاكه الحقيقة المطلقة. وأطراف لبنان أكثر تعدادًا من أطراف الأخطبوط، وحقائقهم المطلقة أكثر قدسيةً من الكتب السماوية.
لن تهزم دموعي نتنياهو أو تنزع عنه صفة مصّاص الدماء، لن تُخجل ادرعي فتدفعه ليلهو بلعبةٍ أخرى غير التلهي بأعصاب اللبنانيين وحياتهم. لن تجعل دموعي العالم الغربي أكثر رأفةً، ولا حكوماته أكثر صدقًا وأقلّ انفصامًا. وسيبقى العالم العربي نكتة سمجة انهمرت دموعي أم لم تنهمر.
لن تفعل دموعي شيئًا. لن تجعل من سجون النظام السوري قصّصًا مُفبركة كما فعل بعض الإعلام المحلي والغربي؛ وكأن الفظاعة التي شهدها سجن صيدنايا تحتاج الى تأليف سيناريوهات تافهة لتأكيد المؤكد. لو استجابت دموعي لرغباتي لحرّرتني من ثقل عجزي وقهري وقلّة حيلتي. كأنني في البكاء أقول أنني فعلت ما يمكن فعله، وهو اللافعل. البكاء فعل أناني يحرّر جهازي العصبي، لا أكثر. لو طاوعتني دموعي لحافظت ربّما على إنسانيتي، ولكن عصيانها ربّى الوحش الصغير في داخلي ونمّاه.
قبل نيّفٍ وعام اعتكفت الحياة. لازمت زاويتي وتحوّلت متفرّجة على حرب العالم المتحضّر على غزة وشعبها وعلى الجنوب اللبناني وأهله( وإن بوتيرة أقلّ عنفًا في البداية). قبل نيّفٍ وعام انقطعت عن الطعام والشراب حين جاعوا وعطشوا، رفعت عنّي الغطاء حين بردوا واطفأت المكيف حين الهبتهم الشمس الحارقة والرطوبة العالية. كنت إنسانًا يشعر ويتألّم ويكاد أن يموت من القهر. ثمّ تخلّت عني إنسانيّتي رويدًا رويدًا. صرت أُطفىء التلفاز حين أرغب في تناول الطعام. قرّرت أنّني لا أريد أن أرى وأسمع وأعرف. وكأنّ في هذا الخيار تعبير عن انسانيّة من الطراز الرفيع. ” ما بقى فيني اتحمل، أو اهترت اعصابي، أو تعبت نفسيتي”. وكأنّ هذه المشاعر هي جواز سفر إلى الحياة مجدّدًا وسط الدمار وآلة القتل الهمجيّة ، العنف الذي استعصى وصفه على لغة الضاد . إسرائيل أصبحت صفة تعطي الواقع حقّه وأكثر.
تسلّلت تدريجيّا إلى الحياة، في الخفاء تارةً وفي العلن طورًا. ولكلّ “فعل حياتيّ” مبرّره وتبقى أبهى هذه المبررات، “غريزة البقاء” ! شعارٌ لم استعمله قط، بل سمعته من كثيرين أقدموا على الحياة أو برّروا إقدامي عليها. أي غريزة وأي بقاء ؟ بقائي لم يكن مهدّدا حتى حين اتّسعت الحرب الإسرائيلية على لبنان ودمّرت البشر والحجر. كان يمكن لبقائي أن ينهيه حادث سيرٍ أو التعثر ببحصةٍ على الطريق أكثر من احتمال أن تنهيه الحرب الإسرائيليّة على لبنان. فأنا أقيم في منطقةٍ لا تدخل ضمن الأهداف الإسرائيلية، وقد زادت فيها الأعلام التي تحدّد هويتها السياسية، ما دام “الدرون” شغّال ويلتقط صورا يمينًا ويسارًا. كثيرون بالمناسبة، تحدّثوا عن هذه الغريزة، ومنهم من يقيم في المقلب الآخر من كوكب الأرض. لست هنا بصدد محاكمة أحد، والكلام لا يتعدى معنى غريزة البقاء لمن ليسوا تحت وطأة خطرٍ داهمٍ، وأنا منهم. لا شجاعة في إقدامي على الحياة، فالشجاعة هناك حيث يُواجه الغزّاويون آلة الموت والجوع والعطش والصقيع وحدهم. الشجاعة عند أقدام المقاومين، الشجاعة عند أهالي الجنوب والضاحية والبقاع. الشجاعة عند الأسرى في سجون نظام الأسد، عند المنسيين في سجون الدكتاتوريات العربيّة، الشجاعة عند المعتقلين في السجون الإسرائيليّة. هذه غريزة بقاء. أمّا أنا فلا شيء .
أصبحت شخصين، أنظر بطرف عيني للشخص الآخر الذي كنت عليه، الشخص الذي يستجدي الدمع ليعبّر عن وجعه. أشيح بنظري عنه، أستعجل الحياة، أتجمّل إستعدادًا لاستقبال السنة الجديدة، أنظر في المرآة ، فأراني وحشًا…