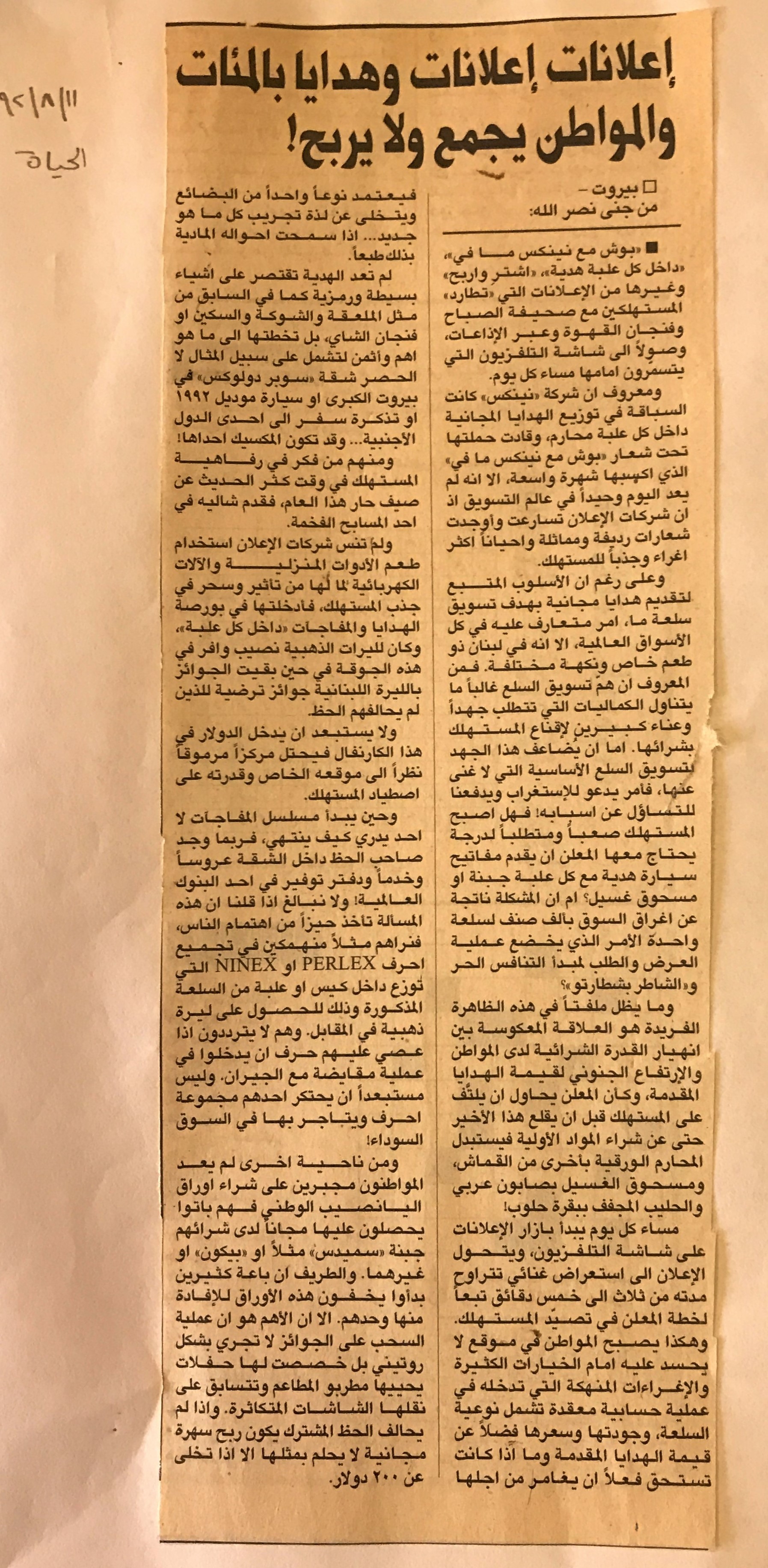«أوف، شو عملوا فينا»، عبارة تردّدها في داخلك وأنت تشاهد فيلم «نجوم الأمل والألم». قد لا تنجح في أن تُبقيها همسًا داخليًا، فيخرج الإنفعال على شكل تمتمة خافتة. لا حرج في أن تقولها بصوت عالٍ، أو أن تردّد عبارة مرادفة لها مثل «شو مرق علينا»، وأنت على يقين بأنّ كلّ من يشاهد الفيلم يشاركك الشعور نفسه. لا يترك لك الفيلم مسافة آمنة بينك وبينه، بل يضعك في قلب تجربة تشبهك. أنت أمام مرآتك. شريط أحداثه… هو شريط حياتك. تتماهى معه. تصبح شريكًا. بطلًا من أبطاله، أو بمعنى أدق، مواطنًا من مواطنيه. إنّه فيلم عنّا نحن اللبنانيين وتحديدًا «جيل الحرب»، تلك التسمية التي تستدرج الشقفة على أنفسنا، نحن الذين لم يفتنا القطار فحسب، بل دهسنا تحت عجلاته. والقطار، أو بالأحرى سكّة الحديد، مكانٌ محوري في الفيلم من دون أن يُحمّل أي معنًى مجازيًا. إنّها سكّة وُجدت في زمن يسبق زمن بطليّ الفيلم نينو (حسن عقيل) وياسمينا (منية عقل)، وانتهى دورها قبل ولادتهما على الأرجح. لم يبق منها سوى هيكل متآكل يغزوه الصدأ، لكنّه يتحوّل إلى مساحة للقاء طفلين يهربان إليه من كلّ ما يزعجهما. إنّها ذاكرة نحاول جاهدين الحفاظ عليها، رغم الندوب التي أصابتها والتشوهات التي نالت من جماليتها، أو من خصوصيتها المرتبطة بنا كأفراد.
يحكي فيلم «نجوم الأمل والألم» عن الحرب، بل عن الحروب اللبنانيّة. تلك المادّة الحيّة التي لا تزال تمّد الفن السابع اللبناني بوقودٍ لا ينضب، وتتوارثها الأجيال في نسخٍ أكثر عنفًا ووحشيّة. تمتد مساحة الفيلم على ثلاثين عامًا، تحكي الحرب بأشكالها المتعدّدة وإفرازاتها المدمّرة، على خلفيّة قصّة حب تجمع طفلين على سكّة الحديد، ثم تفرّقهما الظروف، لتعيد الصدفة جمعهما ثانيةً. ويكاد انهيار البلد عمومًا والانهيار الإقتصادي خصوصًا أن يفرّقهما من جديد. ورغم أن قصّة الحب تتقاطع مع بعض كلاسيكيات الأفلام الهوليوديّة، حيث تذهب ياسمينا لتبحث عن نينو في المكان الذي تعرف أنّه يهرب إليه دومًا، أي سكّة الحديد، فإنّ هذا التأثّر لم ينتقص من سلاسة العلاقة العاطفية التي شكّلت القماشة التي طُرزت عليها أحداث الفيلم. قصّة لا تخرج عن المألوف السينمائي، إذا صحّ القول، لكّنها حُبكت برومانسيّة لطيفة، من دون مبالغة أو ابتذال، فجاءت الأحداث في سياق إنساني حقيقي غير مفتعل، منذ لحظة الافتتان الأولى مرورًا بالأزمات والخلافات التي تنتاب أي علاقة، وصولًا إلى مواجهتهما مصيرهما المشترك. ولا شكّ في أنّ التناغم بين البطلين حسن عقيل ومنية عقل مضافًا إلى رقّة نينو وطرافته وجاذبية ياسمينا وإتقانها لعبة التطواطؤ مع شريكها، أضفى نكهة مميّزة على هذا الفيلم. بهذا المعنى، كان اختيار المُمثّلين موفّقا جدًا، بدءًا من المخضرمين مثل جوليا قصار وكميل سلامة وصولًا الى الطفلين الذين لعبا دور ياسمينا ونينو أيام الطفولة، من دون أن ننسى طبعًا الشيف (تينو كرم) وزوجته (نادين شلهوب).
شكّلت مشاهدة هذا الفيلم متعة تمتّد لساعة وخمسين دقيقة، لا يعكّرها سوى دموع تنهمر فرحًا وحزنًا. فيلم مؤثّر منذ لحظاته الأولى حتّى النهاية. مؤثّر في عفويته من دون تبسيط، في واقعيته من دون مبالغة، في ألمه حدّ البكاء وفي أمله، الذي لا يعدو نجمتين مطرزتين في السماء.
وفي المناسبة، يبدو عنوان الفيلم باللغة الإنكليزية A sad and beautiful world (عالم حزين وجميل)، أكثرمطابقةً لروحه، من العنوان الذي اختير له باللغة العربية« نجوم الأمل والألم ». واستطرادًا، فالأمل، إن وجد، يأتي بعد الألم، لا قبله.
ملفتةٌ الحرفيّة في هذا الفيلم، وخصوصًا أنّه أوّل فيلم طويل للمخرج سيريل عريس. ولا مبالغة في اعتباره تحفةً فنيّة تتخطّى الإطار اللبناني، ما جعله يحصد أكثر من جائزة منها جائزة الجمهور في مهرجان البندقية، وجائزة اليسر لأفضل سيناريو في مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي، كما دفع الدولة اللبنانية، ممثّلةً بوزارة الثقافة، إلى ترشيحه لتمثيلها في جائزة الأوسكار. أخيرًا وليس آخرا، إذا استعرتُ من الموسيقى لوصفه، لقلتُ إنّه مقطوعة متكاملة؛ يتصاعد إيقاعها السردي بتناغم، فيما تأتي الموسيقى نوتةً تمنح المشهد حميميّته، وتضفي ذلك الدفئ الذي يسري في روح المشاهد جنبًا إلى جنب مع الألم، أمّا الأمل، فيبقى خيارًا شخصيّا.